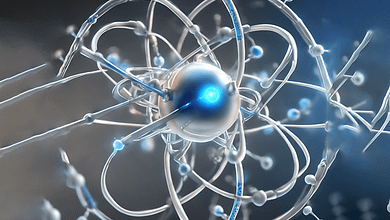لم يعد الموت والنهاية ، في العلم الحديث، مجرّد حدث غامض يُسلِّم إليه الأطباء ثم ينسحبون في صمت. في العقود الأخيرة ظهر ما يمكن أن نسمّيه مجازًا “علم الموت”: حقل متنامٍ يدرس لحظة الاحتضار، وما يحدث للجسد والدماغ عند انتقال الإنسان من حالة الحياة إلى حالة الوفاة، وكيف يمكن أن يعيد هذا الفهم تشكيل نظرتنا للحياة نفسها.
هذا الاهتمام العلمي تجلّى في تقارير صحفية وتحقيقات معمّقة، من بينها مواد نشرَتها The Guardian تناقش أبحاثًا جديدة حول نشاط الدماغ في لحظات الموت، وتصف كيف بدأ الأطباء والعلماء يتعاملون مع الموت كـ”عملية” يمكن رصدها وفهمها، لا كحدّ فاصل بسيط بين الأبيض والأسود.
ولًا: متى يموت الإنسان؟ من الخط الفاصل إلى “المنطقة الرمادية”
لسنوات طويلة كان تعريف الموت يبدو بسيطًا: توقّف القلب والتنفس. لكن مع ظهور أجهزة الإنعاش والتنفّس الاصطناعي ومراقبة نشاط الدماغ، أصبح الواقع أكثر تعقيدًا:
- يمكن إيقاف قلب المريض ثم إعادته للعمل بعد دقائق عبر الإنعاش القلبي الرئوي.
- يمكن إبقاء الجسد على الأجهزة لأسابيع مع توقّف شبه كامل للوعي.
- يمكن تسجيل نشاط كهربائي في الدماغ بعد توقّف القلب لثوانٍ أو دقائق. University of Chicago News+1
هنا ظهر مفهوم “موت الدماغ” (Brain death) كتعريف طبي وقانوني في كثير من الدول: عندما يتوقف نشاط الدماغ توقفًا كاملًا غير قابل للعكس، يُعتبَر الإنسان ميتًا، حتى لو كانت الأجهزة تبقي القلب والرئتين في حالة عمل اصطناعي.
الأبحاث الحديثة – التي تتناولها تقارير صحفية علمية – تُظهر أن الخط بين “الحياة” و”الموت” ليس لحظة حادة بقدر ما هو منحنى زمني:
مرحلة يدخل فيها الجسد تدريجيًا في الانطفاء، ويمكن أحيانًا إعادته عبر الإنعاش، وأحيانًا يكون التراجع قد تجاوز نقطة اللاعودة.
أكثر ما أثار الجدل في “علم الموت” الحديث هو ما تمّ تسجيله من نشاط دماغي غير متوقَّع في لحظات قريبة من الموت، وأحيانًا بعد توقّف القلب.
ثانيًا: ماذا يحدث في الجسد عند الاقتراب من الموت؟
دراسة الموت لا تتم في المختبر فقط، بل أيضًا في غرف المرضى وبيوتهم. في أحد تقارير The Guardian التي تستعرض شهادات ممرضات مختصات برعاية المحتضرين، يُقدَّم الموت كـعملية جسدية طبيعية ومنظّمة أكثر مما نتخيّل:
1. مرحلة الانتقال (Transition)
قبل أسابيع أو أيام من الوفاة في الحالات المتوقَّعة (مثل السرطان أو الأمراض المزمنة المتقدّمة)، يلاحظ الأطباء والممرضون:
- انخفاض الشهية والعطش: الجسد يتراجع عن استهلاك الطاقة لأنه “يعرف” أنه في المراحل الأخيرة.
- زيادة فترات النوم: المريض ينام أكثر ويقظته تقل، كأن الوعي نفسه ينسحب تدريجيًا.
- تراجع الاهتمام بالمحيط: ينسحب الشخص قليلًا من الحياة اليومية، يتوقف عن الاهتمام بالأخبار والتفاصيل الصغيرة.
هذه المرحلة كثيرًا ما تفسَّر خطأ على أنها “اكتئاب” أو “استسلام”، لكن المتخصّصين يرونها جزءًا من برنامج جسدي–نفسي طبيعي استعدادًا للنهاية.
2. مرحلة “الموت الفعّال” (Active dying)
في الأيام أو الساعات الأخيرة، تظهر علامات أكثر وضوحًا:
- فقدان الوعي أو الوعي المتقطّع.
- تغيّر في نمط التنفس (مثل تنفّس متقطّع غير منتظم يعرف طبيًّا بـ Cheyne–Stokes).
- ما يُعرَف بـ”خرخرة الموت” (Death rattle): صوت ناتج عن تجمع الإفرازات في الحلق مع ضعف قدرة المريض على البلع أو السعال.
- برودة الأطراف وتغيّر لون الجلد مع تقلّص الدورة الدموية.
في بعض الحالات، يصف الأطباء والمرافقون ظاهرة تُسمّى “الصحوة النهائية” أو “الانتعاش الأخير” (Terminal lucidity): لحظات أو ساعات قصيرة من صفاء ذهني غير متوقّع قبل الموت مباشرة، حتى عند مرضى بأمراض دماغية متقدّمة.
هذه الظاهرة ما زالت غامضة، وتطرح أسئلة عن طريقة عمل الدماغ في المراحل الأخيرة.
ثالثًا: ماذا يحدث في الدماغ في لحظة الموت وما بعدها؟
أكثر ما أثار الجدل في “علم الموت” الحديث هو ما تمّ تسجيله من نشاط دماغي غير متوقَّع في لحظات قريبة من الموت، وأحيانًا بعد توقّف القلب.
1. موجات غامّا و”استرجاع الحياة”
بحسب تقرير طويل لـ The Guardian عن “العلم الجديد للموت”، قام باحثون بتسجيل نشاط دماغي لمرضى في العناية المركّزة أثناء سحب أجهزة الإنعاش عنهم تحت إشراف عائلاتهم. المفاجأة كانت ظهور اندفاعات قوية من موجات دماغية عالية التردّد (موجات غامّا) مرتبطة عادة بالوعي والتركيز واسترجاع الذكريات، وذلك في اللحظات التي سبقت الوفاة مباشرة.
دراسات أخرى على الحيوانات، مثل تجارب جامعة ميتشغن على الجرذان، أظهرت نمطًا مشابهًا من الاندفاع الكهربائي في الدماغ بعد توقّف القلب مباشرة، ما دفع بعض الباحثين لاقتراح أن الدماغ قد يمرّ بحالة “نشاط فائق” في اللحظات الأولى من الموت.
هذه النتائج فتحت الباب أمام فرضيات أن الدماغ ربما يقوم خلال ثوانٍ أو دقائق بنوع من الاسترجاع الكثيف للذكريات، وهو ما يستحضره البعض عند الحديث عن شعور “مرور شريط الحياة” الذي يرويه بعض من مرّوا بتجارب الاقتراب من الموت.
لكن الأهم علميًا هو:
هذه البيانات تقول إن الدماغ لا ينطفئ ببساطة مثل مفتاح، بل يدخل في حالة معقّدة ما زلنا نفهمها جزءًا جزءًا.
2. تجارب الاقتراب من الموت (Near-Death Experiences)
حقل آخر متشابك مع “علم الموت” هو دراسة تجارب الاقتراب من الموت (NDEs): روايات أشخاص توقّف قلبهم أو دخلوا غيبوبة عميقة ثم عادوا للحياة، ويروون خبرات مثل:
- الإحساس بالخروج من الجسد.
- رؤية ضوء ساطع أو نفق.
- لقاء أقارب متوفين أو كائنات نورانية.
- شعور قوي بالسلام أو الانفصال عن الألم.
منذ السبعينيات ظهر حقل بحثي كامل يدرس هذه الظاهرة، وظهرت جمعيات متخصّصة ومجلّات علمية حولها.
أحد أبرز الأسماء في هذا المجال هو الطبيب سام بارنيا، المتخصّص في الإنعاش القلبي والرعاية الحرجة، والذي قاد دراسات واسعة مثل مشروع AWARE لدراسة الوعي أثناء الإنعاش. هذه الأبحاث تحاول التحقّق من مدى تطابق روايات المرضى مع أحداث جرت بالفعل أثناء فقدانهم للوعي، باستخدام اختبارات معيّنة في غرف الإنعاش
حتى الآن:
- لا يوجد إجماع علمي على تفسير واحد لهذه التجارب.
- بعض الباحثين يميلون إلى تفسيرها كنتاج لنشاط دماغي غير اعتيادي تحت الضغط الشديد ونقص الأكسجين.
- آخرون يرون أنها تطرح أسئلة حقيقية حول طبيعة الوعي وحدوده.
المهم هنا أن العلم نفسه دخل إلى منطقة كان يُعتقَد سابقًا أنها فلسفية أو دينية فقط. University of Chicago News
رابعًا: من “تابو الموت” إلى “ثقافة معرفة الموت”
بالتوازي مع الأبحاث البيولوجية والعصبية، ظهر اتجاه آخر يُسمّى أحيانًا “ثقافة الموت” أو Death literacy: دعوة لتعليم الناس – مرضى وأسرًا – ما يحدث عند الاحتضار، وكيف يتغيّر الجسد والنفس، وكيف يمكن أن تكون تجربة الموت أقل رعبًا لو فهمنا آلياتها.
التقارير المعاصرة – ومنها تقارير The Guardian – تشير إلى أن: The Guardian
- الحديث المفتوح عن الموت،
- وشرح مراحله الجسدية والنفسية،
- والاستعداد له قانونيًا (مثل الوصايا والتوجيهات الطبية المسبقة)،
كلها تقلّل من القلق الوجودي عند المرضى وأقاربهم، وتساعد على اتخاذ قرارات أكثر إنسانية في نهاية الحياة، بدل ترك كل شيء لصدمة اللحظة الأخيرة.
خامسًا: علم الموت… ماذا يضيف، وما حدوده؟
1. ما الذي يقدّمه لنا العلم؟
- فهم أفضل لحدود الإنعاش
من خلال دراسة نشاط الدماغ والقلب أثناء التوقّف والإنعاش، يمكن تحسين بروتوكولات الطوارئ، وزيادة فرص إنقاذ المرضى دون إحداث أذى دماغي دائم. University of Chicago News - رعاية أرحم في نهاية الحياة
معرفة أن “الخرخرة” أو تغيّر لون الجلد أو التوقف عن الأكل جزء من المسار الطبيعي، يساعد العائلات على تقبّل ما يحدث، ويقلّل من شعورها بالذنب. The Guardian - إعادة تعريف الموت كعملية لا كلحظة
الأبحاث الحديثة تجعلنا ننظر إلى الموت كسلسلة مراحل يمكن رصدها، بعضها قابل للعكس (عبر الإنعاش)، وبعضها نقطة لا عودة بعدها. The Guardian+1
2. أين يقف العلم؟
مع كل هذا، هناك أسئلة لا يملك العلم – بطبيعته – إجابة نهائية عنها، مثل:
- ماذا يحدث للوعي بعد توقّف الدماغ نهائيًا؟
- هل تجارب الاقتراب من الموت لمحات من “عالم آخر” أم نشاط دماغي داخلي صرف؟
هذه الأسئلة تبقى في منطقة يتداخل فيها الإيمان، الفلسفة، والتجربة الشخصية. العلم يمكنه أن يصف ما يحدث للخلايا والأمواج الكهربائية والهرمونات، لكنه لا يستطيع أن يحسم معنى ما وراء ذلك.
أن نفهم الموت لكي نفهم الحياة
“علم الموت” لا يهدف إلى نزع القداسة عن الموت أو تحويله إلى أرقام وبيانات باردة، بل يمكن أن يُفهم بطريقة أخرى:
- حين نعلم أن الدماغ يظلّ يعمل لثوانٍ أو دقائق بعد توقّف القلب، ندرك هشاشة الحدّ بين “الغياب” و”الحضور”.
- حين نفهم مراحل الاحتضار، نتعلّم كيف نرافق مرضانا وأحبتنا بطمأنينة أكبر.
- حين نرى أن الموت عملية تدريجية، نُسأل ضمنيًا: ماذا نفعل بالحياة التي ما تزال في متناولنا الآن؟
في النهاية، قد يكون أهم ما يقدّمه لنا هذا الحقل الجديد هو أنه يدعونا إلى التوقّف عن التعامل مع الموت كموضوع محظور، وأن نراه بواقعية وهدوء كجزء من البنية الطبيعية للوجود.
فهم الموت لا يلغيه، لكنه يتيح لنا أن نعيش حياةً أكثر وعيًا، وأن نحضر لحظة الفراق – حين تأتي – بقدر أقل من الفزع، وبقدر أكبر من الإنسانية.