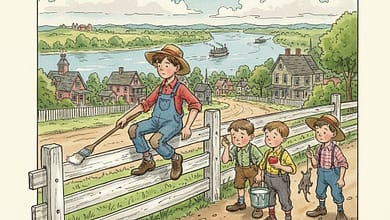قراءة في طرق تخيّل العالم وإعادة كتابته سرديًا
عندما نتحدّث عن الخيال في الرواية، فنحن لا نتحدّث فقط عن القدرة على اختراع أحداث وشخصيات، بل عن طريقة رؤية العالم: كيف يُبنى الصراع؟ من يتكلّم؟ من يُسْمَع؟ ومن يُقصى من المشهد؟
من هنا ظهر في النقد الأدبي الحديث ، الحديث عن الخيال الذكوري والخيال الأنثوي
عندما نقرأ رواية كتبها رجل، وأخرى كتبتها امرأة، لا نقرأ فرق الأسلوب فقط، بل نقرأ – في العمق – فرق الجسد الذي يحلم ويكتب. خيال الرجل ينطلق غالبًا من تجربة جسدٍ ذكري تربّى على فكرة أن له حق الحركة، التجربة، المبادرة، وأن العالم مفتوح أمامه ولو نظريًا. أما خيال المرأة، فينطلق من جسدٍ أنثوي عاش الحصار أو المراقبة أو الخوف أو التقييد، حتى لو كان هذا الجسد قويًّا من الداخل ومقاومًا.
ماذا نقصد بالخيال الذكوري والانثوي ؟
لهذا، حين نتحدّث هنا عن «الخيال الذكوري» و«الخيال الأنثوي»، فنحن لا نقصد نمطًا نقديًا مجرّدًا، بل نقصد خيال الرجل بوصفه خيال جسدٍ ذكري، وخيال المرأة بوصفه خيال جسدٍ أنثوي؛ أي أن جنس الكاتب نفسه – في مجتمع أبوي – يترك أثره العميق على طريقة تخيّله للعالم، وللجسد، وللرغبة، وللعلاقة بين الرجل والمرأة.
اقرأ ايضا ماذا نعني بالطاقة الانثويه
الخيال الروائي، عند أي كاتب أو كاتبة، هو القدرة على تحويل التجربة الحياتية إلى صور وحكايات، وإعادة ترتيب الواقع أو فضحه أو تجاوزه. لكنه لا ينطلق من فراغ؛ بل من موقع محدّد داخل شبكة السلطة والعادات والتربية. الرجل يدخل الخيال عادة من موقع من يُتوقَّع منه أن يكون الفاعل والمبادر، ومن يُعطى حق النظر والحكم والرغبة. المرأة تدخل الخيال غالبًا من موقع من يقع تحت النظر، تحت التقييم، تحت السؤال عن شرفها وسمعتها قبل أن يُسأل عن أفكارها ووعيها.
من هنا، يبدو الفارق في خيال الاثنين واضحًا حين يقتربان من الموضوعات نفسها: الجسد، الحب، الجنس، الزواج، السلطة، الضعف، والتمرّد. الموضوع واحد، لكن زاوية الدخول إليه مختلفة جذريًا.
الأمر نفسه يظهر، بصورة أوضح وأقسى، في “موسم الهجرة إلى الشمال” للطيب صالح؛ حيث تتحوّل النساء الأوروبيات في حياة مصطفى سعيد إلى ساحات يمارس فيها انتقامه ورغبته وسيطرته
كيف يظهر الخيال الذكوري في الرواية ؟
في كثير من الروايات التي يكتبها الرجال، يظهر الخيال الذكوري أولًا في طريقة النظر إلى جسد المرأة. غالبًا ما تُقدَّم الشخصية الأنثوية من الخارج قبل الداخل: الجسد، المشية، لون البشرة، تفاصيل الوجه، طريقة اللباس، وكيف «تظهر» أمام العيون. في “زقاق المدق” لنجيب محفوظ مثلاً، تُقدَّم حميدة أساسًا من خلال حضورها الجسدي في الزقاق، وكيف تتجه إليها نظرات الرجال، قبل أن تُقدَّم كوعي مستقل أو مشروع ذاتي. الجسد هنا هو بطاقة التعريف الأولى، وهو مركز الكاميرا قبل أن نتعرّف على صوتها من الداخل.
الأمر نفسه يظهر، بصورة أوضح وأقسى، في “موسم الهجرة إلى الشمال” للطيب صالح؛ حيث تتحوّل النساء الأوروبيات في حياة مصطفى سعيد إلى ساحات يمارس فيها انتقامه ورغبته وسيطرته. نحن لا نعرف هؤلاء النساء كذواتٍ كاملة، بل كـ«محطات لذة» أو نهايات مأساوية مرتبطة به هو، بسرديته هو، وبجرحه هو. المرأة هنا ليست صاحبة قصة مستقلة بقدر ما هي فصل في قصة الرجل ورحلته مع نفسه ومع الاستعمار ومع الشرق والغرب.
هذا التركيز على الجسد لا يأتي وحده؛ بل يصاحبه عادة تمركز الرغبة الذكورية بوصفها محور الحكاية. السرد يدور حول ما يريده الرجل من المرأة، كيف يسعى إليها، كيف يغزو عالمها، كيف ينجح أو يفشل، وكيف تُهدّد رجولته إن رفضته أو قاومته. كثير من الروايات تجعل المرأة معيارًا لقياس «نجاحات» البطل العاطفية أو الجنسية: كل علاقة انتصارٌ جديد، أو جرح جديد، لكنه في النهاية يظل هو صاحب الحكاية، وصاحب الصوت الأعلى في التنظير لما حدث.
إلى جانب ذلك، يتمتّع الكاتب الرجل في الغالب بقدرٍ من الحماية الاجتماعية حين يقترب من هذه الموضوعات الحسّاسة. حين يكتب عن تفاصيل الجسد، أو عن تجاربه الجنسية، أو عن خياناته، يُقدَّم ذلك كثيرًا بوصفه جرأة أدبية، وتحطيمًا للتابوهات، وصراحةً تستحق الاحترام. يصف جسد المرأة بدقة، يذكر تفاصيل اللقاء، يتحدث عن لذّته هو، وعن شعوره هو، دون أن يضطر للدفاع عن سمعته الأخلاقية أمام قارئيه. الجرأة هنا ليست فقط لغوية، بل أيضًا جرأة موقع: يكتب من مكان من يملك حق الكلام، لا من مكان من يحاسَب على كل اعتراف.
حركة هذا الخيال الذكوري تكون – في معظم الأحيان – من الخارج إلى الداخل. يبدأ من المغامرة، السفر، العمل، السياسة، الحروب، ثم يدخل إلى الداخل عبر أثر هذه الأحداث على البطل وعلاقاته بالنساء. المرأة في هذه البنية تظهر تابعة لمسار البطل، تبلغ الذروة معه أو تسقط معه، لكنها نادرًا ما تمتلك مسارًا موازيًا يحمل الثقل نفسه في النسيج السردي.
كيف يتشكل الخيال الانثوي؟
في المقابل، حين تكتب المرأة روايتها، يتشكّل الخيال الأنثوي بصورة مختلفة تمامًا. الجسد لا يعود صورة تُرى من الخارج، بل يتحوّل إلى ذاكرة كاملة. في “امرأة عند نقطة الصفر” لنوال السعداوي، تروي فردوس جسدها بوصفه مسرحًا للبيع والاغتصاب والاستغلال، ثم بوصفه ساحة صحوة متأخرة وقرار عنيف بالرفض. الجرأة هنا ليست في رسم مشاهد صادمة لمجرّد الإثارة، بل في تسمية العنف كما هو، وكشف البنية الاجتماعية والسياسية والدينية التي حوّلت هذا الجسد إلى سلعة.
الجسد الأنثوي في خيال المرأة ليس مجرد «جسد جميل» أو «مثير»، بل جسد يشعر ويتذكّر، يحمل آثار الطفولة، والقهر، والمرض، والولادة، والخوف، والاشمئزاز، والمتعة أيضًا. إنه شيء يتحسّس العالم من خلاله، لا مجرد شكل يخضع لنظرات الآخرين. المرأة وهي تكتب جسدها، تستعيده من العيون التي وقفت عند سطحه، وتحوّله إلى مساحة وعي وتجربة.
الفارق الأوضح بين الطرفين يظهر عندما نركّز على صيغة السرد نفسها. كثير من الرجال يكتبون جسد المرأة من موقع “أنا أريد”: أنا أراها، أنا أشتهيها، أنا أقترب، أنا أملك، أنا أترك
الرغبة كذلك تظهر بصورة مختلفة حين تكتبها المرأة. الكاتبة تدرك أن رغبة المرأة – في مجتمعها – ليست أمرًا مسموحًا به ببساطة؛ هي محاصَرة، ومثقلة بالرقابة والأحكام. لذلك تميل كثير من النصوص الأنثوية إلى التركيز على الصراع الداخلي الذي تعيشه البطلة بين رغبتها وبين الخوف، بين ما تشتهيه وما تسمح به القيم السائدة، بين صوتها الخاص والصوت الجمعي الذي يراقبها ويحاكمها. الرغبة ليست استعراضًا لانتصارات أنثى على الرجال، بل سؤالًا شائكًا: ماذا أريد حقًّا؟ وما الثمن الذي سأدفعه لو اعترفت بهذا أمام نفسي وأمام الآخرين؟
في أعمال رضوى عاشور، مثل “ثلاثية غرناطة”، لا تحتل الأجساد بمعناها البصري مركز المشهد، بل تحتلّه حياة النساء كما هي: أدوارهن في حفظ اللغة، مقاومة الاضطهاد، حماية الأبناء، حمل عبء اليومي، وحراسة الذاكرة في ظلّ انهيار عالم كامل. الأجساد هنا تُرى من خلال التعب، الشيخوخة، الحمل، الفقد، الصمود الطويل، لا من خلال جمل الوصف الشهواني. التاريخ نفسه يُعاد كتابته من خلال عيون النساء، لا من خلال تقرير المؤرخين فقط.
الخيال الأنثوي يتحرّك غالبًا من الداخل إلى الخارج. يبدأ من سؤال: من أنا؟ ماذا فعل بي هذا العالم؟ ماذا فعل بي هذا الأب أو الزوج أو العشيق أو القانون؟ ومن خلال الحفر في هذا الداخل، تتكشف صورة الخارج: النظام الأبوي، القمع، الفقر، الحرب، الدين، القضاء، الشرطة. الأحداث الكبرى لا تأتي هنا كخبر سياسي أو ملحمة تاريخية فحسب، بل تمر عبر جسد محدّد، وذاكرة محدّدة، وحياة امرأة بعينها.
الفارق الأوضح بين الطرفين يظهر عندما نركّز على صيغة السرد نفسها. كثير من الرجال يكتبون جسد المرأة من موقع “أنا أريد”: أنا أراها، أنا أشتهيها، أنا أقترب، أنا أملك، أنا أترك. هي موضوع رغبتي، وهي جزء من حريتي في التجربة، حتى لو عانيت بعدها من الندم أو الفقد. أما كثير من النساء فيكتبن أجسادهن من موقع “ماذا فعلوا بي؟ وماذا أريد أنا فعلاً؟”: ماذا فعل هذا العالم بجسدي؟ كيف استُخدم ضدي؟ أين تبدأ رغبتي الخاصة وسط رغبات الآخرين في امتلاكي أو السيطرة عليّ؟
وحين تكتب المرأة عن جسد الرجل، نادرًا ما تتعامل معه كغنيمة جسدية معكوسة؛ لا تختزله عادة في عضلاته وتفاصيله الجسدية كما يفعل كثير من الرجال مع النساء. تراه غالبًا بوصفه موقع سلطة: أبًا، زوجًا، رئيسًا، شيخًا، ضابطًا، مديرًا… تراه صورة لبنية كاملة، لا مجرد جسد يُشتهى. ذلك يعني أن الخيال الأنثوي يربطها عادةً بأسئلة أوسع: الأمان، المشاركة، الاحترام، الخيانة، الحماية، لا بمجرد المتعة كهدف نهائي.
قد يبدو منطقيًا أن تتجه بعض الكاتبات إلى عكس الصورة تمامًا: أن يكتبن الرجال كما كتبت الرواياتُ النساءَ، أجسادًا بلا وعي، وأدوات متعة بلا تاريخ. لكن هذا نادر؛ لأن المرأة تعرف بحكم تجربتها قسوة أن يُختزل الإنسان في جسده، وتدرك أن هذا الاختزال نفسه جزء من المشكلة التي تتحرك كتابتها ضدها. لذلك، حتى حين تغضب، وحتى حين تفضح، فإنها لا تميل غالبًا إلى استنساخ المنطق نفسه في الاتجاه المعاكس.
مع ذلك، لا يمكن اختزال الواقع في ثنائية حادة. هناك رجال يكتبون بخيال يقترب كثيرًا من التجربة الأنثوية، يحاولون الإنصات إلى داخل المرأة، يمنحونها صوتًا وعمقًا لا يقل عن عمق البطل، ويشكّكون في امتيازاتهم الذكورية داخل النص. وهناك نساء يكتبن أحيانًا بعين المجتمع الأبوي نفسه، فيدين جسد المرأة قبل جسد الرجل، أو يحصرن بطلاتهن في دور التضحية والصبر من أجل البطل، أو يختصرن خلاص المرأة في الزواج فقط.
لكن، على الرغم من هذه التعقيدات، يبقى الأصل واضحًا في أغلب النصوص: خيال الرجل الروائي يتحرك من موقع من يملك حق النظر والرغبة والمبادرة، وخيال المرأة الروائية يتحرّك من موقع من سُلِب منها هذا الحق وتحاول استعادته، أو على الأقل تسمية الجرح الذي خلّفه غيابه.
في النهاية، ربما يكون السؤال الأهم في قراءة أي رواية من هذه الزاوية بسيطًا في صياغته، عميقًا في نتائجه: من الذي يحلم هنا؟ جسد مَن الذي يتخيّل، وجسد مَن الذي يُتخيَّل؟ حين نجيب عن هذا السؤال، سنكتشف غالبًا أن الفرق بين الخيال الذكوري والخيال الأنثوي ليس فرقَ أسلوب فقط، بل فرق موقع، وجرح، وحقّ في الكلام، وحقّ في أن يكون الإنسان هو صاحب جسده، وحكايته، وصورته في الخيال.